«فرش وغطا».. التجريب لا يكون في الجمهور بل معه (مقال تحليلي)
other
رامي عبد الرازق
من بين 15 فيلمًا تشارك في مسابقة «الأفلام الروائية الطويلة» ضمن فعاليات الدورة السابعة لمهرجان «أبوظبي السينمائي»، الممتد من الفترة 24 إلى 31 أكتوبر، يتمثل الحضور المصري ضمن منافسات المسابقة بفيلم «فرش وغطا»، الذي كتبه وأخرجه أحمد عبد الله السيد، وإنتاج محمد حفظي، وسبقا أن تعاونا معًا في فيلم «ميكروفون»، الذي يقوم ببطولته آسر ياسين، ويعرض للمرة الأولى في الوطن العربي، بعد أن شهد مهرجان «تورنتو السينمائي» العرض العالمي الأول للفيلم.
يشارك «فرش وغطا» هذا العام ثلاثة أفلام عربية ضمن مسابقة «الأفلام الطويلة» بالمهرجان، وهي «بلادي الحلوة.. بلادي الحارة»، للمخرج هينر سليم من العراق، وفيلم «تحت رمال بابل» للمخرج العراقي الشاب محمد دراجي، الذي شاهدنا له قبل أعوام قليلة فيلمه المميز «ابن بابل»، وأخيرًا فيلم المخرج الجزائري الكبير مرزاق علواش «السطوح»، الذي يمثل عودة قوية لهذا السينمائي ابن حي «باب الواد» بعد فيلمه الأخير «التائب»، الذي أجمع النقاد على أنه لم يكن على مستوى صاحب التجربة المهمة «عمر قتلته الرجولة».
في نهاية فيلم «فرش وغطا» وبعد التيترات نقرأ أن عنوان الفيلم مستوحى من لون غنائي شعبي صعيدي عبارة عن مبارزة ارتجالية بين الشعراء، وهو ما يذكرنا بتلك الإشارة البصرية العابرة لشريط كاسيت يمسك به بطلنا الهارب آسر ياسين أثناء رحلة عودته للقاهرة صبيحة اليوم التالي لـ«جمعة الغضب» عقب فتح السجون، وتهريب المساجين.
دعونا من مسألة أن قليلين هم من يتابعون تيترات الفيلم الأخيرة ليتعرفوا على أي معلومة مفيدة، وكان الأجدى إلى جانب تلك الكلمات القليلة في تيتر البداية عن الظرف الزمني للأحداث، أن يضع الكاتب تعريف الفرش والغطا في أول الشريط، وليس في نهايته كي يصبح المشاهد على دراية بأن ثمة صلة بين هذا الشكل الغنائي وبناء الفيلم أو حتى مضمونه.
لكن هل هناك بالفعل صلة بين الفرش والغطا كشكل غنائي وبناء الفيلم أو مضمونه، أم أن الكاتب أراد فقط أن يشير إلى أصل العنوان سواء كانت له صلة بالبناء والمضمون أو لا؟
في الحقيقة كان بناء الفيلم بالطريقة التي صاغها «عبد الله» توحي بأن ثمة صلة بين الاثنين، خاصة في المستوى الشكلي الخاص بالغناء الصوفي، الذي يستمع إليه الشاب الهارب في المقابر اثناء إصلاح المعدات الكهربائية، والذي يقابله الترنيم المسيحي في «دير سمعان الخراز»، أثناء تشييع جنازة صديقه المسيحي، الذي قتل أثناء التهريب من السجن، كذلك في محاولة صناعة تقابل معنوي بين شرائح المسلمين الفقراء من سكان المقابر وشرائح المسيحيين الفقراء في حي الزريبة الخاص بتجميع القمامة، وإن كان مفهوم الفرش والغطا الغنائي، كما عرفه المخرج في النهاية، هو أقرب للمنازلة منه، ولم نشعر بأن ثمة منازلة بين الفئتين، لأن كليهما يعاني من المشاكل الاجتماعية والسياسية نفسها، التي تجعله لا منتمى بشكل أو بآخر.
لا يمس هذا الشكل المضمون كثيرًا، فالمخرج هنا لا يقارن بل يكثف وضع الشرائح الدنيا في المجتمع، وبالتالي فكرة النزال مستبعدة.
ثم إن تعبير «فرش وغطا» في دلالاته الشعبية أو المتعارف عليها أقرب لمضمون الفيلم، لأنه تعبير يختصر أبسط متطلبات الحياة بالنسبة لقطاع كبير من المصريين، الذين حاول «عبد الله» أن يقترب منهم بفيلمه، والمقصود به أن مجرد العثور على فرش أي «مكان للنوم»، و«غطاء»، أي «للتدفئة والستر» كفيل بأن يشعر الكثيرون بأن الحياة على ما يرام، وأن أحلامهم فيها تحققت، وهو ما نرصده من خلال موتيفة الفرش والغطا، التي تلازم البطل في كل مكان يذهب إليه أثناء رحلته الغريبة.
قبل تيترات البداية يقدم لنا المخرج كليبا حقيقيا عن إحدى وقائع تهريب المساجين من «سجن القطا»، ويستمر هذا الكليب معنا كوثيقة «ديكو/ درامية» طوال الفيلم كشاهد على بعض ما حدث من خلال موبايل الصديق الميت.
وعلى مستوى الشكل يقدم لنا «عبد الله» جسرًا بصريًا من خلال محاكاة أسلوب الكليبات المصورة بالموبايل أثناء عمليات الهروب، سواء على مستوى الصورة المهزوزة أو الصوت المتداخل أو الجودة البصرية المنخفضة والمتقطعة، إلى أن يستقيم شكل الفيلم بصريًا بعيدًا عن هذا السياق، ويأخذ خط السرد في متابعة رحلة الشاب الهارب، ولكن فكرة الصورة المهزوزة تستمر للأسف فكريًا بشكل أو بآخر مع الرحلة رغم ما فيها من منطقية وتصاعد جيد.
أول عناصر الصورة الفكرية المهزوزة هو شكل «البانتوميم» الغريب، الذي اتخذه المخرج لعمله، فشخصيات الفيلم لا تتحدث تقريبًا بشكل واضح، ولا يوجد حوار كلامي متصل ومسموع طوال الفيلم تقريبًا باستثناء «اللقاءات التليفزيونية» الغريبة، التي يجريها الشاب مع بعض شخصيات الرحلة.
يقول «بريسون» إن الفيلم هو بناء علاقة بالنظرات، لكنه يقول أيضًا إنه لا يجب أن تهب صورة لتحل محل صوت أساسي، بمعنى أن من حق المخرج أن يستغنى عن الحوار بالصورة قدر الإمكان، لكن هذا ليس معناه أن تتحول الشخصيات إلى صم وبكم تتحدث بالعيون والإشارات والأصابع.
هناك مفاصل كلامية عادية وطبيعية تحتاج إليها الشخصيات، كي تبدو عادية، وليست بأداء تمثيلي، أي على حد قول «بريسون» مرجعنا الأساسي في هذا السياق: «من غير أن تنقصهم الطبيعة، تنقصهم الطبيعية»، أي أن الشخصيات بلا كلمات أو جمل مفصلية تبدو غير طبيعية ومفتعلة ومستفزة للمتلقي، الذي لم يتمكن المخرج من إقناعه بأسباب الصوت الخفيض، أو الكلام المدغم، وكأن الشخصيات تتحدث «على جوه» أي إلى الداخل.
الأزمة أن هذا الشكل «البانتومايمي» استحوذ على الكثير من طاقة المخرج في «الغلوشة» أو التشويش على الصوت الطبيعي، كي يبدو عند سماعنا إياه أمرا عاديا ومنطقيا مثل مشهد جلوس البطل بجانب موتوسيكل يحدث ضجيجا يمنعه من سماع حوار صديقه خادم الجامع مع المنشد الصوفي، كي يقنعه بالذهاب لإنقاذ الصديق المسيحي المصاب في الصحراء.
هذا التشويش عقب بضعة مشاهد يصبح غير متقبل ومفتعل وغير ناضج بل مستفز، ليس لأننا نريد أن نسمع، فالحدث بسيط، والصورة معبرة عنه بلا حوار، لكن لأننا نريد أن نشعر بأن الأمور تسير بشكل طبيعي وواقعي، كي يكتمل الإيهام الخاص بالسرد والحكاية في ذهننا، هذا نوع من الألعاب غير الموفقة على مستوى الشكل العام للفيلم.
في تجربتيه السابقتين «هليوبوليس»، و«ميكروفون» كانت لدى «عبد الله» شخصية صامتة أساسية في سياق شخصيات أخرى تتكلم وتصمت مثل باقي البشر، هما شخصيتا عسكري الحراسة في «هليوبوليس» وبائع شرائط الكاسيت في «ميكروفون»، وكان الأمر متقبلًا، بل فنيًا بدرجة كبيرة، ولكن أن تتحول كل شخصيات الفيلم إلى حالة صمت وحديث بالنظرات بلا منطق سردي أو بصري حقيقي فهي لعبة لم تحقق المتعة المرجوة من ورائها، وصارت كأن المخرج يجرب في الجمهور أن يقدم لهم فيلمًا بلا حوار، والتجريب لا يكون في الجمهور، لكن مع الجمهور، أي مع ما يكون مستوعبًا أو محسوسا بالنسبة لهم حتى لو لم يكن مفهومًا بشكل كامل، المهم أن يحقق الإيهام اللازم كي يقتنع المتفرج بما يشاهده حتى لو كان فانتازيا.
ماذا استفاد المتلقي من كون الفيلم بلا حوار بالمعني التقليدي، هل كثف هذا من المشاعر أو عمق الأفكار؟
على العكس، أصبح عائقًا أمام استغراق المتفرج في مشاعر الشخصيات وأفكار الواقع المطروح، بل صنع حالة سلبية من التغريب ما بين المتلقي والعمل، لأنه شغل ذهن المتلقي باستكمال الحوار الناقص أو حتى تصوره.
وهل صار الفيلم أقل مباشرة عندما نزع عنه المخرج روح الحوار؟
الإجابة أيضًا لا، لأن مشاهد البوح والفضفضة التي أطلقنا عليها حوارات تليفزيونية جاءت مليئة بالمباشرة، التي تبدو أيضا خارج سياق العمل ككل.
هل من أجل أن أحكي عن الطبقات المهمشة، أو التي تحولت إلى لا منتمية، وأصبحت غير مهتمة بما يحدث في البلد، بسبب انغلاقها على نفسها في المقابر وأحياء الزبالة أن أحضرها كي تجلس أمام الكاميرا وتحكي للبطل الدرامي ـ وليس الممثل ـ عن معاناتها فأفهم أنا من ذلك كمشاهد سبب خروج المصريين في 25 يناير؟
هذا هو ما حدث في الفيلم، وهو تبسيط مخل سواء للشكل أو السياق الفكري العام للتجربة، بل إننا لا نعرف لماذا تحكي هذه الشخصيات للبطل معاناتها، وما الذي أوجد ثقة وأرضية مشتركة تجعل مؤجر المراجيح أو صبي الزبال يشتكيان لهذا الشخص تحديدا دون سابق معرفة أو صلة؟
هل يقوم البطل ببحث اجتماعي لكل شخصية يلتقي بها أثناء رحلة هروبه أو محاولة إيصال رسالته إلى أسرة صديقه المسيحي المقتول في تلك الأجواء الجحيمية، التي يعتقل فيها الجيش الناشطين بناء على وشايات من البلطجية، أم أن هذا المشهد مكتوب وقت أن كان المجلس العسكري يحكم مصر قبل أن يتولى الإخوان الحكم؟
وهل ينتقص من صورة الفيلم الفكرية لو حذفنا هذه المشاهد المباشرة الفجة؟
إطلاقا بل على العكس ستعكس الصورة بمفهومها الإخراجي والسينمائي قسوة الواقع، وأسباب الانتفاضة ــ بتعبير المخرج في بداية الفيلم ــ أكثر من تلك الشكوى الميلودرامية، التي اقتحمت علينا السياق والشكل.
ونأتي للحديث عن هذا الواقع القاسي، الذي يتوغل فيه «عبد الله» لأول مرة بهذا الشكل، نحن نعرف من خلال مشاهد التليفزيون، التي تبثها «الجزيرة» أن الأوضاع مشتعلة في البلد، لكننا نجد تلك الطبقات سواء في المقابر أو عزبة الزبالين تعيش حياتها بشكل عادي وطبيعي، فالمنشدون في المقابر كل همهم أن يصلحوا السماعات والأجهزة الخاصة بالإنشاد، وكأنهم على موعد لفرح أو مولد، بينما البلد مشتعل في الخارج، وكذلك الزبالون الذين يعملون في عملية فرز الزبالة، وإعادة تدويرها، وكأنهم يخرجون كل يوم لجمعها وسط أجواء الثورة والحظر وما إلى ذلك.
السؤال هنا: هل هذا هو الأسلوب الذي يمكن أن نعبر به عن طبقات لا منتمية أصبحت خارج سياق المجتمع، بسبب تهميشها وضياع حقوقها السياسية والاجتماعية؟
بالطبع لا، لأن أرسطو يقول: «المستحيل الذي من الممكن الإيهام به دراميًا خير من الحقيقي، الذي لا يجد أسباب تحققه في النص فلا يصدقه الجمهور»، بمعنى أنه حتى لو كانت تلك الطبقات على هذا الحال وقت الثورة، فيجب أن تبذل أنت كمخرج جهدًا كي تقنعني بهذا، لأنني كمتفرج لن أصدق أن هناك من لم يكن جالسًا أمام التليفزيون يتابع البلد المقلوب، حتى لو كان هذا حقيقيا وواقعيا، المهم كيف أثبته أنت في فيلمك وأقنعتني به.
سؤال آخر: هل من يجلس بعيدًا عن أحداث الثورة، ويغني وينشد في وجد صوفي، أو يعمل كالآلة في عملية تدير القمامة هو نفسه من خرج وانتفض في الخامس والعشرين؟
إذن لماذا لا نراه في التحرير أو ضمن المنتفضين طالما امتلأ بأسباب الخروج كما يدعي صناع الفيلم؟
أغرب مشاهد الفيلم مشاهد الإنشاد الصوفي، التي تبدو مفتعلة ومدعية جدًا، وخارج سياق الفيلم الفكري، وحتى الشعوري، فلا نحن ندري هل يغني المنشدون من باب التسلية أم التمرين أم محاولة للقضاء على التوتر فيما يخص الأحداث المشتعلة؟
لذا من الطبيعي ألا نصدق أن أحدًا وسط هذا الكم من العنف والدم وقت جمعة الغضب وما تلاها كان يمكن أن يجلس للغناء والدندنة سوى ثوار ميدان التحرير، ونعود لنقول حتى لو كان هذا صحيحًا فأين أسباب الإيهام التي تثبت لنا هذا؟
نحن أمام فكرة جيدة كان من الممكن أن تصنع فيلمًا عالي المستوى ومؤثرا وانفعاليا، لكن تشوش الرؤية السينمائية والفكرية لدى المؤلف الذي هو المخرج وضعنا أمام سياق آخر يحتوي على بعض المزايا، لكنه مليء بالعيوب والثغرات.
شخصية السجين الهارب الذي لا نعرف له اسمًا ولا تهمة هي شخصية جيدة، وهي في جانب منها لا بطل يتأثر بالظروف والملابسات من حوله في النصف الأول من الفيلم، وفي جانب آخر بطل حقيقي له موقف إنساني بل مواقف كثيرة، بداية من تصليح نور الجامع، من أجل علاج المصابين في المظاهرات، رغم أن الجامع مضاء من الداخل، ولا حاجه لإقامة مستشفى ميداني خارجه، أو محاولته المستمرة في أن يفي بوعده للعوده إلى زميله المصاب، أو توصيل الخطاب منه لأسرته عقب وفاته، وهو نمو في الشخصية، وتحول درامي جيد، لكن تظل الأزمة في سياق مشوش ومتخبط، لأن القصة دراميًا حتى لو كانت لا خطية ــ أي لا تتبع الشكل التقليدي للحكاية الدرامية ــ تظل مشوقة ومتصاعدة ومليئة بالدلالات والإشارات، التي لم تكن في حاجه إلى بلورتها بشكل وثائقي مباشر.
إخراجيًا تقدم أحمد عبد الله كثيرًا على مستوى التكنيك والتعبير بالصورة عن المشاعر والأفكار، وما أضره هو تفريغ الفيلم من الحوار، لأنه استهلك جانبًا من طاقته وتركيزنا في مشاهد منزل شقيقة بطلنا الهارب ومشاهد المسجد، وتفاوت الصورة ما بين الغائم والواضح، تمامًا كحالة الحيرة والتخبط والخوف، التي تعاني منها الشخصية، كذلك اختيار الكثير من الزاويا المعبرة من وجهة نظر الشخصية الرئيسية عن أفكارها أو هواجسها وأفكارها، خاصة في مشاهد المقابر، والتعلق العاطفي المشبوب بابنة المنشد.
توظيف مصادر الإضاءة الطبيعية في مشاهد حي الزبالين، والبحث عن مصادر منطقية تفيد الظلال والواقع الكئيب، واختيار مواضع للكاميرا تعبر عن حالة عدم الاستقرار أو الدهشة أو الغربة الواقعية مثل اللقطات المأخوذة من فوق السيارات النقل، أو من داخلها أثناء رحلة البطل من السجن أو إلى المقابر وحي الزبالين.
الاستخدام المقتصد للموسيقى وتوظيف برويهات الأماكن، والتعامل مع الصمت كحالة صوتية معبرة عن الوحدة أو القلق، أو الشعور بالعزلة مثل مشهد صعود بطلنا إلى إحدى لوحات الإعلانات، والجلوس وحيدًا يتأمل القاهرة العشوائية من فوق.
كل هذه ميزات شكلية وأسلوبية كان من الممكن أن تصبح أكثر بريقًا لو أنها تطابقت مع مضمون واضح وقوي ومحدد أو على الأقل محسوس وممنطق، وهو للأسف ما لم يتحقق بشكل كبير خلال تجربة أحمد عبد الله الثالثة.
يبقى فقط أن نشير إلى أن آسر ياسين في حالة مميزة سواء على مستوى تقمص شخصية السجين الهارب المصاب والحائر والمعزول بداخله، أو على مستوى الأداء الجسماني والحركة البطيئة المتوجسة، والنظرات التي تبدو وكأنها تخشى الإفصاح عما يدور في داخلها، خوفًا من افتضاح أمره، أو شكًا في مشاعره، ومدى تقبل الآخرين لها.
انتقص فقط غياب الحوار العادي من طبيعة أدائه، لأنه يحمل فكرة إضغام الكلام والوشوشة وتحريك الشفاه بلا حوار حقيقي، وباستثناء ذلك كان يمكن أن يكون هذا الدور إحدى العلامات الواضحة في مشواره الفني كأحد أهم الوجوه الشابة في السينما المصرية والعربية.


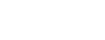


اكتب تعليقك